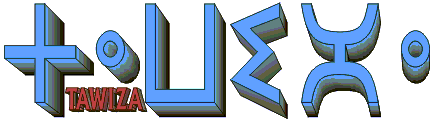 |
uïïun 159, sayur 2960 (Juillet 2010) |
|
|
|
الفراعنة الأمازيغ (الجزء الثاني) بقلم: سعيد بودبوز إن شيشنق الأول لم يكتف بالتدخل في السياسة المصرية، قبل اعتلائه العرش المصري، بل تدخل حتى في شؤون الكهنة مع العلم أنه كان قد حصل على لقب ديني في مصر إضافة إلى لقبه السياسي. ورغم أنني لا أملك ما يكفي من الأدلة على أن سيطرة الأمازيغ على مصر قد ترتب عنها نوع من التغيير الكهنوتي(الديني)، الذي ربما أصبح نسبيا في صالح الشعب المصري نسبيا، إلا أنني أظن بأن المصريين، في ذلك الوقت، كانوا يرون في الحكم الأمازيغي ما يقربهم إلى بعض الحرية بالمقارنة مع النظام الفرعوني الذي لم يكن يكبلهم بأصفاده الاستعبادية فحسب، وإنما كانوا يعانون أوتوقراطية كهنوتية دينية تبارك هذا الاستعباد السياسي باسم الألهة المعنية بالأمر كالعادة، وتجعله قائما على منطق الرب وشريعته، وهذا هو الأخطر لأنه الأصعب والأكثر تجذرا. لست هنا لأهاجم الحضارة الفرعونية، كما قد يظن البعض، فالحق أنها أكبر من أن يهاجمها أحد، ولكن ما أقوله يمكن استخراجه من كلام المؤرخين الذين تحدثوا عن مصر القديمة وعلى رأسهم اليوناني هيرودوت. فمن خلال حديث هذا الأخير عن السكان المتاخمين لبلاد الأمازيغ، وأنهم كانوا يفضلون أن يكونوا أمازيغ (ليبيين)، وقد بعثوا إلى معبد آمون يدَّعون أو يطلبون الإذن بالانسلاخ عن الهوية المصرية، أعتقد أن هؤلاء المصريين كانوا أدرى بشعابهم وكانوا يعرفون جيدا لماذا فضلوا الانتماء إلى الأمازيغ عن انتماءهم إلى مصر الفرعونية. حتى وإن افترضنا بأن هؤلاء كانوا يتواجدون داخل الأراضي الأمازيغية، كما أشار الدكتور أحمد بدوي، وبالتالي كان رفضهم للهوية المصرية يعكس الواقع السيادي للبلد، إلا أن الأمر لن يتغير إذ يمكننا أن نطرح السؤال كالتالي: مادامت الأمور السيادية في يد القيادة، كما يعرف الجميع، فلماذا تولت هذه الشريحة الشعبية مهمة الإرسال إلى معبد آمون بغرض توضيح هويتهم؟ ثم، لو كان الحكم الفرعوني أفضل من الحكم الأمازيغي وأقرب منه إلى الشعب آنذاك، أفلم يكن من المعقول أن نجد هؤلاء يبعثون إلى معبد آمون يدعون بأنهم مصريون وليس العكس؟ أعتقد أن بعض المؤرخين، الذين تحدثوا عن هذه الفترة، من تاريخ مصر القديمة، ينسون التطرق إلى مثل هذه التفاصيل والدقائق مع أنها قد تكون لها أدوار حاسمة في بعض التحاليل التاريخية. إن ما لا شك فيه أن حضارة الفراعنة تكاد لا تصدق لعظمتها إلا أنه لا بد من القول بأن ذلك قد تم على حساب الشعب. فالأهرامات، على سبيل المثال، لا يمكن بناؤها في ظل حكم اشتراكي أو ديمقراطي، إن جاز التعبير، وذلك لأنها لم تكن تعني الأغلبية، التي تتكون من البسطاء المصريين، في شيء. فهي لم تكن قريبة من حياتهم اليومية. وبالتالي لم يكونوا يرون فيها إلا شهوة الفرعون وطغيانه ونزوعه نحو الاستعباد.لا بد من القول بأن تلك الأهرامات تدل على الشرخ الأعظم الذي كان قائما بين الحاكم والمحكوم في مصر آنذاك. من الجدير أن نذكر بأن ما نراه نحن الآن، من مظاهر الحضارة الفرعونية، مبهرا لم يكن كذلك بالنسبة للشعب المصري القديم. فها هو هيرودوت يشير إلى تلك الأصفاد الكهنوتية التي كانت تكبل الشعب المصري بأعداد مخيفة من طقوس الدين والعبادات التي كانت تصب كلها في خدمة الفرعون الحاكم وطبقة الكهنة. نحن ننظر إلى حضارة الفراعنة من الخارج وننبهر لكن لو كنا من الشعب الذي تم بناء هذه الحضارة على أكتاف أفراده لكان لنا رأي آخر. وهذا لا يعني أنني ضد ما جاءت به أخبار وآثار حضارة النيل العظيمة، بل أحاول أن أصل إلى ما تيسر من الواقع الفرعوني الشعبي الذي كان قائما آنذاك لا أكثر ولا أقل. إذن ينبغي القول بأن الفراعنة قد نجحوا في إيصال حضارتهم إلينا وأن لكل شيء ثمنا في النهاية دون أن يتنافى ذلك مع النظرة الموضوعية إلى الظروف التاريخية والسياسية التي اكتنفت ميلاد هذه الحضارة. إذا لم ينس المؤرخ مثل هذه الأمور وحاول أن يتمثل الأجواء المدنية، التي بنيت فيها تلك الحضارة، فسوف ينظر إلى هذه الأخيرة من تاريخها الداخلي وليس الخارجي، وإذا نظر إليها من تاريخها الداخلي فسيدركها من داخل السياق أيضا وليس من خارجه. وهذا يعني أنه لن يبدأ من الأهرامات، في تناول التاريخ الحضاري الفرعوني، بل سيبدأ من مظاهر العيش اليومي للمصريين أولا لأن ذلك لا يسهل عليه تفسير الأوضاع الاجتماعية أو السياسية، التي كانت قائمة في ذلك الوقت والبلد فحسب، وإنما قد يساعده على تفسير حتى طبيعة التفاعل السياسي الخارجي لهذا البلد مع البلدان المجاورة. هذا ما يجعلنا ميدانيا نقترب شيئا فشيئا من فهم طبيعة الاستيلاء الأمازيغي على عرش مصر وطبيعة استمراره في الحكم دون أن يتعرض لثورات المصريين طوال تلك المدة. هذا أجدى من أن نضع الأمور بين نظريتين لا ثالث لهما؛ وهي إما أن يكون الأمازيغ قد حكموا بإرادة المصريين وبطريقة سلمية، كما يقول بعض المؤرخين، وإما أن نقول بأنهم حكموها بالقوة، هكذا دون أن ندخل إلى الواقع الذي كان يلامسه الشعبان آنذاك ونفهم، بصورة تقريبية، ماذا كان يجري خلف الكواليس. ففي إطار فهمنا للحيثيات والأجواء، التي كانت سائدة قبيل استيلاء الأمازيغ على مصر بقيادة "شيشنق الأول"، يمكن أن نقترب قليلا من فهم طبيعة السيطرة الأمازيغية على مصر. وذلك من خلال استيعاب ما يمكن من طبيعة جذورها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قبل العسكرية الحاسمة. إذا كان هناك، في مصر الفرعونية، من كان يعاني من الضيق الذي تحدث عنه المؤرخ اليوناني هيرودوت، وأن السكان المتاخمين لبلاد الأمازيغ كانوا يريدون الانسلاخ عن مصر، للأسباب المذكورة سالفا، فلقد كانت مصر، علاوة على ذلك، قد دخلت في نوع من الاحتضار الاقتصادي الناجم عن الإمعان في الاستخفاف بالشعب المصري لدرجة مخيفة. لقد حصل هناك إنفاق مخيف على المعابد بتبذير وإسراف هستيريين على حساب الشعب المصري طبعا. على سبيل المثال" تذكر بردية "هاريس" أن دخل هذه المعابد وحدها بلغ في عهد رمسيس الثالث ما يعادل 62 كيلو من الذهب و1189 كيلو جراما من الفضة 2855 كيلوجراما من النحاس وأن مراعيه كانت تؤدي 42362 رأسا من الماشية الكبيرة والصغيرة، أهدي منها رمسيس الثالث 28337 رأسا دفعة واحدة، كما دخل معابد مصر حيذاك نحو مائة ألف مكيال من الغلال، واستأثرت بخيرات 169 مدينة وقرية في مصر وخارجها وامتلكت أكثر من 88 سفينة ونحو 50 ترسانة لصناعة السفن وإصلاحها"[28]. فانطلاقا من هذه المعطيات، كأمثلة على الأوضاع الاقتصادية المزرية التي كان يعيشها الشعب المصري في ذلك الوقت، يمكن أن نفهم أكثر ما معنى أن يتحدث هيرودوت عن تفضيل بعض المصريين للهوية الأمازيغية، أو بالأحرى الانتماء إلى بلاد الأمازيغ. مما لا شك فيه أن هذه الأرقام تعتبر غنية عن التحليل، فهي احتضار اقتصادي واضح يدل على التهميش العظيم الذي تعرض له المصريون آنذاك وخاصة في عهد رمسيس الثالث. أكيد أنا لا أعني أن الأمازيغ قد سيطروا على مصر في عهد رمسيس الثالث، ولكن ما جاء ذكره من الفساد الاقتصادي وغيره كان يمهد لذلك بلا شك. يضيف أحمد عبد الحليم، إلى ما ذكرته أعلاه من كلام هيرودوت عن ضغوط الدين التي كان المصريون عرضة لويلاتها، فيقول: "علاوة على كل هذا كانت هذه المعابد لا تؤدي ما هو مفروض عليها من الضرائب، وذلك لتولي عائلات كبار الكهنة للوظائف المهمة في الدولة" [29]. وهكذا كانت حدة الأزمة تسير في خط تصاعدي "وقد زاد فراعنة هذه الفترة من الحدة الاقتصادية التي كانت تعاني منها مصر وذلك عندما أسرفوا في إقامة المنشآت المعمارية، فحفروا مقابر ضخمة على غرار من سبقوهم في العصور الزاهية." [30]. ربما كان ما يجري، ضد الشعب المصري آنذاك، في صالح الأمازيغ على كل حال وليس بمقدورنا أن ننكر رغبة البلدان في استعمار الأخرى حتى وإن كنت أعتقد بأن الأمازيغ كانوا مخلصين، إلى حد ما، للعرش المصري، وأن استيلاءهم على مصر لا يدل إلا على أنهم كانوا شعبا متحضرا واعيا جدا، وإلا فمن كان سيمنعهم من استئصال الأخضر واليابس المصريين بحيث يقومون بالشطب على كل المنجزات الفرعونية التي تعود إلى الفراعنة المصريين السابقين طوال مدة حكمهم؟ نحن نعرف ماذا فعل المغول في بغداد وغيرها، لأنهم شعب همجي بامتياز. وما كان للهمجي أن يفعل أقل من ذلك، أما الأمازيغ، الذين حكموا مصر، فإن الآثار المصرية كلها تشهد بأنهم كانوا في غاية الوعي والتحضر، وأنهم لم يسيئوا إلى كتابة أو أثر أو كنز أو غير ذلك أبدا. ولكن للأسف نرى المؤرخين يتغاضون عن هذه الأمور، في كثير من الأحيان، إن لم نقل يتغاضون عنها دائما وكفى. لقد كانت فرنسا تحمل بواخر تلو أخرى من الكنوز والأرزاق من مستعمراتها، وعلى رأسها المغرب والجزائر، حتى أنها كانت تنهب كل صغيرة وكبيرة بما في ذلك التين المغربي، مع العلم أن الاستعمار الفرنسي جاء في وقت متأخر من الزمان والتاريخ. ولقد كان يفترض به أن يكون أكثر وعيا من الأمازيغ القدماء الذين حكموا مصر قبل ألاف السنين!. ولكن يجب أن نقول، بصراحة، إن الأمازيغ القدماء قد احترموا أرض النيل، سواء دخلوها بالقوة أو بالسلم، وأنهم إذا كانوا قد استولوا على العرش المصري في سنة 950 أو سنة 945 قبل الميلاد فبكل بساطة ومسؤولية أقول بأنهم، والتاريخ يشهد، كانوا أكثر إخلاصا لمصر من الإسبان والفرنسيين الذين دخلوا المغرب سنة 1912 بعد الميلاد. لنحاول ما أمكن من التدقيق في هذه النقطة وذلك بأن نستجليها في ضوء المقارنة الممكنة بين طبيعة الحكم الأمازيغي والفرعوني القديمين، إذا كان الحكم الفرعوني معروفا بالاسترقاق شبه المطلق، فإن الأمازيغ بكل بساطة لم يكونوا كذلك، بل كانوا يتمتعون بحرية لا بأس بها نسبيا بالمقارنة مع الفراعنة "وكانت السلطة في القبيلة لرئيسها أو ملكها، وإلى جانبه يوجد مجلس القبيلة المكون من كل الرجال الكبار. وكان المجلس يجتمع كما هو الحال بالنسبة لقبائل الأوسيس كل ثلاثة أشهر أي مرة في كل فصل من فصول السنة. [31]. ويعرف المؤرخون بأن الأمازيغ القدماء كانوا يتمتعون بما يمكن أن نسميه الحكم الفدرالي حيث كان لكل قبيلة رئيسها أو شيخها وفي النهاية نجد لهؤلاء الرؤساء رئيسا أكبر، وهو بمثابة الرئيس الفدرالي في يومنا هذا، وكان هناك حكم ديموقراطي نسبيا بالمقارنة مع الآخرين أو الفراعنة بالتحديد. حتى أن بعض النقوش المصرية قد تحدثت عن رئيس الرؤساء أو الزعيم الأعظم للمشوش أو الليبيين (الأمازيغ). يقول الدكتور مصطفى كمال عبد العليم: "وإذا انتقلنا من مجتمع الأسرة إلى مجتمع القبيلة، وجدنا أنه كان يرأس القبلية زعيم أو رئيس من أسرة معينة تحتكر لنفسها زعامة القبيلة. وكان هذا الزعيم ينحى عن الرئاسة إذا ثبت عدم كفاءته، ويعهد بمنصبه إلى أحد أعضاء[32] الأسرة الآخرين، كما حدث في حالة الأمير "مريي بن دد" الذي ولي أخوه مكانه. ومن نصوص الملك رمسيس الثالث، نعرف أن هذا الملك أمر أن يحضر إليه "الأسرى العشرة". ويرجح أن هؤلاء العشرة كانوا يشكلون مجلسا استشاريا يتعاون مع رئيس القبيلة في إدارة شؤونها. وقد تكررت في نصوص هذا الملك أيضا عبارة "رؤساء المشوش" وأشير في الأسرة الثانية والعشرين الليبية إلى "زعماء أرض مشوش" الرئيس الأعظم للمشوش و"رئيس الرؤساء". ولما كنا نرى في الصور التي حفظتها جدران المعابد في مصر بعض المشوش يتحلون بريشة واحدة وآخرين يتحلون بريشتين، فإن ذلك، فيما يرجح ، يعتبر علامة على تباين المركز الاجتماعي"[33]. هذا يعني أن الأمازيغ كانوا يعيشون في ظل حكم فدرالي آنذاك، أو لنقل كانوا يعيشون في ظل حكم قريب من الصيغة الفدرالية المعروفة حديثا. إذا حاولنا تمثل السياق السياسي القديم الذي يعود، على الأقل، إلى هذه الفترة فسنجد بأن الحديث عن رئيس الرؤساء والمجلس الاستشاري وقابلية الحاكم للتنحي عن الحكم هو بمثابة الحديث عن المدينة الفاضلة، مما يدل على أن الشعب الأمازيغي كان له حظ ما في القرار السياسي للبلد الذي يعيش فيه. هذا في حين نجد أن السياسة الفرعونية، كما يعلم الجميع، كانت تقوم على تأليه الحاكم ولا مجال للمشاركة الشعبية في الحكم على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد. فلا بد أن يكون المصري القديم قد أحس بهذا الفرق في ضوء احتكاكه بالجيران الغربيين. لهذا فأنا أحاول أن أتأمل جيدا حديث هيرودوت عن المصريين الذين كانوا يتاخمون بلاد الأمازيغ وأنهم، كما أسلفت، كانوا يفضلون الانتماء إلى الأمازيغ عن انتمائهم إلى مصر الفراعنة. ومهما تكن وسيلة السيطرة الأمازيغية على مصر فلقد سجل الأمازيغ أدوارا مشرفة فيها، وكانوا معروفين بالبناء والعمران هناك بالإضافة إلى دفاعهم المستميت عن مصر والمحافظة على تقاليد الفراعنة الذين سبقوهم. لقد ذكر الدكتور أحمد بدوي هذه المسألة في شرحه لما ورد في كتاب هيرودوت حين تحدث هذا الأخير عن الملك الذي سماه "آسوخيس". يقول هيرودوت: "ويقول الكهنة أن أسوخيس حكم بعد منقرع" [34]. من هنا يبدأ الدكتور أحمد بدوي شرحه لما ورد في كلام هيرودوت عن آسوخيس فيقول: " إن الذي حكم بعد "منكاورع" مباشرة قد كان "شبسكاف" وله قبر قائم عرف في الكتب العلمية باسم "مصطبة فرعون"، فأما ASYCHIS هذا فيما نذكر أنه ورد ضمن أسماء الملوك عند مؤرخنا الوطني منتون. ولا نذكر كذلك أنه ورد ضمن أسماء الملوك التي دونها الفراعنة في الأثبات التي عرفت في بعض معابدهم أو في القراطيس التي خصصت لذلك. ولربما يبدو طبيعيا أن يظن بعض المؤرخين أن المقصود بهذا الاسم هو "Bochoris وإن كنا لا نعرف له مثل هذا الاسم [35]. كذلك ظن بعضهم أن ذلك الملك هو من أسماه «يوسف اليهودي» (آسوخايوس) ونسب إليه فتح «أورشليم [36]. وبذلك يكون الملك الذي عناه هرودوت هو «شيشنق الأول» وإن كان قد خلط بينه وبين «بوخريس»[37]. ويعلل الدكتور أحمد بدوي هذا التفسير بما عُرف عن الفرعون الأمازيغي شيشنق الأول من البناء فيقول: «وربما يؤيد هذا الزعم ما نسب إليه هرودوت من العمائر الضخمة في معبد «بتاح» وقد كان «شيشنق الأول» من كبار البنائين فعلا» [38]. إذا قلنا بأن هيرودوت كان يعني «شيشنق الأول» بحديثه عن الملك «آسوخيس»، وفقا لما جاء في شرح الدكتور أحمد بدوي، فيمكننا أن نتابع حديث هيرودوت عن هذا الملك إذ يقول: «وهو الذي شيد مدخل معبد «هيفايستوس» الذي يتجه نحو الشرق. وهو أكثر المداخل جمالا وضخامة. فمع أن كل المداخل تحوي أشكالا محفورة وآلافا من المناظر الأخرى للعمارة، فإن هذا المدخل يفوقها جميعا إلى حد بعيد.» [39]. وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين هذا الملك وشعبه في مصر يضيف قائلا: «ويقول الكهنة: إن النقد في عصر هذا الملك كاد يكون معدوما.» [40]. هذا يشير إلى نوع من التقارب والتراضي بين الحاكم والمحكوم إن جاز التعبير. وفيما يتعلق بالأهرامات أظن أنه من الصعب أن نقول، في الوقت الراهن، بأن الأمازيغ قد بنوا أهرامات أو لم يبنوها في مصر، على أننا، إذا ما سلمنا بصحة الشرح الذي ذهب إليه الدكتور أحمد بدوي، في القول بأن حديث هيرودوت عن الملك آسوخيس، هو حديث عن الملك «شيشنق الأول» بالتحديد، نجد أنه ربما كان هناك هرم على الأقل يعود لفترة الحكم الأمازيغي. يقول هيرودوت: «وقد أراد ذلك الملك أن يبز الملوك الذين حكموا مصر قبله، فخلف أثرا عبارة عن هرم مبني من اللبِن، وعليه نقش- محفور على حجر- يقول (لا تحتقرني بالقياس إلى الأهرام الحجرية فأنا أفوقها بقدر ما يفوق زيوس الآلهة الآخرين. فقد أُلقي مسبار في البحيرة فلصق به بعض الطين وأُخذ هذا الطين وصنعت منه لبنات وبهذه الوسيلة كان بنائي» [41]. حتى وإن كنت أحس بشيء من المبالغات، في هذا الكلام، نظرا للمشقة المضاعفة التي يبدو أن هذا الملك قد اختارها سبيلا لتشييد هرمه المزعوم، إلا أن هذا يعني- حسب ماجاء به اليوناني هيرودوت- بأن هناك هرما، على الأقل، يعود بناؤه إلى فترة الأسرة الثانية والعشرين وهي الأسرة الأمازيغية طبعا، ولكن الدكتور أحمد بدوي ينفى أن يكون الأمازيغ قد بنوا أهراما في مصر إذ يقول: "وليس يفوتنا آخر الأمر أن نذكر أن شيشنق وآله جميعا لم يبنوا أهراما، ومهما يكن من شيء فليس لدينا آخر الأمر ما يمكن أن نسند به كل هذا الزعم" [42]. على أنه لا بد من القول بأن نفي الدكتور أحمد بدوي أن يكون الأمازيغ قد بنوا أهراما في مصر يستدعي بالضرورة الشك فيما ذهب إليه من الاستنتاج بأن هيرودوت كان يقصد "شيشنق الأول" بحديثه عن الملك "آسوخيس" لأن هيرودوت يقول بأن هذا الملك قد شيد هرما، ولكن أعتقد بأن من يقرأ هيرودوت سيكتشف بعض الالتباسات الطفيفة في كتاباته على كل حال، وربما يكون أمر تشييد الهرم قد اختلط عليه. أما مسألة اشتهار الأمازيغ بالبناء في مصر فهي ليست خاضعة لهذا أو ذاك الالتباس، لأن أحمد بدوي نفسه جعلها إحدى المسلمات التي استند إليها في الوصول إلى القول بأن هيرودوت كان يقصد" شيشنق الأول" بحديثه عن الملك الذي سماه "آسوخيس". الحق أننا لا نستطيع، كما قلت سالفا، أن نجزم، في الوقت الراهن على الأقل، بأن الأمازيغ قد بنوا أهراما كما لا نستطيع أن نجزم بأنهم لم يبنوها. فما زالت المعطيات الأثرية، وغير ذلك، في طريقها إلى الوجود، وقد تثبت ما ذهب إليه الدكتور أحمد بدوي كما قد تثبت العكس. وطبعا كان هناك دور للأمازيغ في تحرير مصر من الغزاة وعلى رأسهم الفرس. يقول الدكتور مصطفى كمال عبد العليم: "وقد شمل الحكم الفارسي المصريين والليبيين فلا ندهش إذا قرأنا عند هرودوت أنه في عام 460 ق.م. على عهد الملك أرتاخشاشا (أرتاكسر كسين الأول) (464-324 ق.م. هبت في مصر ثورة تزعمها أمير ليبي محلي يدعى ارت حرارو (ايناروس) بن بسماتيك واسمه يوحي بأنه كان من فرع الأسرة السادسة والعشرين القديمة وكان أميرا على الليبيين في المنطقة الممتدة من ماريا (على بحيرة مريوط) حتى فاروس. وقد حالفه امرتي (اميرتايوس) وهو أيضا من سايس."[43]. هكذا كانت مصر بمثابة الأرض الأم للأمازيغ بحيث أصبح الذود عنها هو الذود عن وجودهم "وقد نجح ايناروس في طرد جباة الضرائب وجند فرقا من الجنود المرتزقة. ولم تلبث الثورة أن عمت مصر بأكملها. ثم طلب ايناروس المساعدة من أثينا التي بادرت إلى تأييده وأرسلت أسطولا من ثلاثمائة سفينة، وكانت الحرب سجالا بين الفرس وبين الثوار في الدلتا وانتصر ايناروس في القتال العنيف الذي دار عند بابريميس" [44]. واستماتوا في القتال ضد الفرس إلى أن خانهم الحظ وحالف الفرس "وقد شهد هيرودوت بنفسه ميدان المعركة واستطاع أن يميز قتلى الليبيين بصلابة جماجمهم" [45]. كما مر بنا، هيرودوت يعتبر الأمازيغ أقوياء جدا أكثر من سواهم ولا نتعجب أن يأتي استدلاله عليهم بصلابة الجماجم." ولما دارت الدائرة على إيناروس أُسر وأُحضر إلى سوسا عاصمة الفرس حيث حُكم عليه بالموت وعلى ختم أسطواني للملك الفارسي ارتاخشاشا صور الزعيم الليبي وهو يُذبح. وكان لا يزال يرتدي تاج مصر المزدوج " [46]. ثم إن مصر، بفضل كونها تحت الحكم الأمازيغي، استطاعت أن تلعب دورا إيجابيا في نجدة الأمازيغ في أرضهم الأصلية وراء الحدود الغربية، فعندما نشبت الحرب بين الإغريق والأمازيغ، على سبيل المثال، استنجدوا بالجيش الفرعوني الأمازيغي في مصر "ويقول هرودوت إن الليبيين ومعهم ملكهم أديكران Adicran ذهبوا إلى مصر والتمسوا مساعدة ملكها أبريس. وقد جند أبريس جيشا كبيرا من المصريين لنجدة الليبيين. والتقى هذا الجيش بأهل قوريني عند ايراسا حيث دارت الدائرة على المصريين لأن هؤلاء كما قال هرودوت لم تكن لهم نفس خبرة الإغريق [47]. هنا تجدر الإشارة إلى أن السيطرة الأمازيغية على الجيش المصري لم تنته عند نهاية الأسرة الثالثة والعشرين الأمازيغية، بل استمرت بعد ذلك طويلا، حتى أن الأسرة السادسة والعشرين، كما قلت في بداية هذا المقال، على الأرجح أنها كانت أمازيغية. وهذا قد رأيناه سالفا من خلال حديث الدكتور مصطفى كمال عبد العليم عن ثورة «ايناروس» بن «بسماتيك»، وإن صح هذا فمعناه أن الأمازيغ هم الذين خلصوا مصر من النوبيين الذين سيطروا عليها بعد الأسرة الأمازيغية الثالثة والعشرين. يقول مصطفى كمال عبد العليم في إشارته إلى كون الأسرة السادسة والعشرين أمازيغية وعلاقة ذلك بنجدة الجيش الفرعوني للجيش الأمازيغي في حربه ضد الإغريق: «والتجاء الليبيين إلى المصريين كان أمرا طبيعيا، خاصة وأن الأسرة السادسة والعشرين كانت من سايس، ومن المحتمل جدا أن يكون ملوكها من أصل ليبي، وكان جيشهم يضم عناصر ليبية [48] . لقد كان الملك «أبريس» حكيما إذ لم يرسل فرقة الإغريق من جنوده المرتزقة لنجدة الأمازيغ، ويقول مصطفى كمال: «ولم يكن في وسع أبريس أن يزود الليبيين بالجند المرتزقة من الإغريق الذين كانوا عماد جيشه، وذلك خشية انضمامهم إلى بني جلدتهم من اغريق قوريني» [49]. وإبان الحكم الأمازيغي لمصر توسعت الدولة لتشمل فلسطين وغيرها. فلقد تمكن الأمازيغ الفراعنة من فتح القدس، مثلا، وفي هذا يقول وول ديورانت 1885-1981:"ولم يمض على موت سليمان إلا زمن قليل حتى استولى شيشنق ملك مصر على أورشليم، وحتى سلّمت له ما جمعه سليمان من ذهب بالضرائب التي فرضها على الشعب في أثناء حكمه الطويل"[50]. أعتقد أن ديورانت كان يشير هنا إلى ما جاء في التوراة [51]. خلاصة القول إن حقيقة السيطرة الأمازيغية على العرش الفرعوني في مصر، والتي دامت لأكثر من قرنين ونصف، تتناقض مع ما يميل بعض الكلونياليين إليه من اختزال الأمة الأمازيغية واعتبارها كانت أقل شأنا من غيرها، لأن السيطرة على مصر في تلك الظروف، تبين لنا بأن الأمازيغ لم يكونوا أقل من الفراعنة تحضرا ولا أقل منهم قوة ولا شأنا، ولقد اكتفيت بأخذ أمثلة محددة على ذلك إلا أنها تطرح أمامنا تساؤلا لا شك أن الجواب عنه يقتضي كشف اللعبة، ألا وهي أن تاريخ الأمازيغ القدماء قد تعرض بالفعل للمؤامرات من قبل بعض المؤرخين وربما يكفي أن نعلم بأن الرومان، الذين تحدثوا عن الحضارة الأمازيغية، كانوا أعداءها وهكذا بدأت القصة لتنتهي بالعرب الذين، وللأسف الشديد، لم يكن بعض المتطرفين منهم أقل استبعادا وعداء للثقافة الأمازيغية من غيرهم أبدا حتى وإن حصل بينهم وبين الأمازيغ وئام وتعايش كان ناجحا إلى حد ما ومن الصعب إنكاره. ولكن ذلك قد كان على حساب التاريخ الأمازيغي الذي تم تقزيمة وإهماله واختزاله في تاريخ قريش أو في أغلب الأحوال، المزعوم أن بعضها أكاديمي، نراهم يختزلون الأمازيغ في هجرة حميرية قد يكون وقد لا يكون لها وجود أصلا. كل ذلك لا تخفى أحابيله عن اللبيب الفطن أو حتى الغبي، فإذا تم التنقيب عن التاريخ والثقافة الأمازيغيين القديمين فهذا يعني التقليل من شأن الثقافة الضادية (المحسوبة على العرب) والإسلامية في شمال أفريقيا حسب اعتقادهم. لهذا نرى بعض العرب، حقيقة، أكثر من غيرهم في استعداء الأمازيغ وإن بدا العكس بالنسبة للأمازيغ البسطاء من الناحية الثقافية. أنا آسف لقول هذا رغم أنه حقيقة يعرفها المؤرخ العربي قبلي، لأنني لا أريد، من الناحية الأخرى، أن يتوجه مثل هذا الخطاب إلى بعض المتطرفين الأمازيغ الذين يعتقدون بأن الرد على العنصرية بالمثل يمكن أن يجدي نفعا. فعلى هؤلاء أن يعرفوا بألا مكان للعنصرية إلا في زمن الجاهلية، ومن كان جاهليا فهو مرفوض أيا كانت جنسيته. ثم عندما نتحدث عن العرب فإنما نتحدث عن بعض العناصر الذين لهم علاقة بهذه العنصرية الرسمية والتي لم تتوقف تميل إلى السياسة الاستعمارية. لا يختلف اثنان حول أن العربي التقليدي لا يعرف، ولا يهمه أن يعرف، عن تاريخ شمال أفريقيا ما هو أقدم من أيام عقبة ابن نافع وعمرو بن العاص الخ. فهل نكون نحن عنصريين إذا قلنا هذه الحقيقة؟ بلى، فمن أجل تعميم الفائدة لا ضير أن نصارح بعضنا ونصارح غيرنا بما حدث وما هو قائم. فالعربي التقليدي آخر من يمكن أن يفكر في التاريخ الأصيل والقديم لهذا الشمال الإفريقي، أقول العربي التقليدي حتى لا أجرح بعض المتحضرين الذين تخلصوا من الجاهلية ولم تعد هناك مشكلة بينهم وبين أي عرق آخر. إذن فإن بعض العرب التقليديين، الذين يعرفون أنفسهم في الواقع، أكثر حتى من الرومان المستعمرين في تلذذهم بكل ما من شأنه أن يعيق تقدم الثقافة الأمازيغية إذ تراهم، على سبيل المثال، يتلذذون بكلمة "بربر" بدل كلمة "أمازيغ" مع ما يعرفون في ذلك من الشبهات. ففي الكتابة اللاتينية مثلا نجد، فرقا واضحا بين كلمة "Berbères « وكلمة «Barbares «. والأمازيغ، على كل حال، يسمون أنفسهم « إمازيغن Imazighen» أي «الأحرار»، إذن فمن يصر على أن يسميك بالاسم الذي يتخيله بدل الاسم الذي أطلقه عليك أبوك وأمك، لا يقصد سوى الإهانة الممنهجة. إن المؤرخ العربي النمطي (حتى لا نعمم ففي كل ميدان يوجد شرفاء) كان ومازال يصر على هذا الوصف من أجل ما فيه من الشبهات، ولا يتوانى عن قول «برابرة» أيضا في حديثه عن «الأمازيغ» وفي الحقيقة لا أتصور شتما يمكن أن يوجه إلى الإنسان أكثر من هذا مهما تكن الوسيلة والغاية. فكل ذلك يرسخ الاحتقان ويستعجل الانفصال ويشعل العداء. يؤجج الغرائز ويشعل التطرف المضاد. إذا كان هذا أو ذاك المؤرخ يعتقد بأن سعيه الحثيث، إلى تشويه الأمة الأمازيغية وتاريخها، من شأنه أن يجعل من نفسه ومن تاريخه بديلا عن التاريخ والثقافة الأمازيغيين، بالنسبة للأمازيغ، فهو مخطئ بامتياز. ولا يفوتني هنا القول بأن فرنسا كانت حكيمة جدا عندما اختارت أن تؤسس أكاديمية خاصة للبحث في الثقافة والتاريخ الأمازيغيين، لأنها بذلك سوف تكسب ود الأمازيغ أو تكسب احترامهم على الأقل. حتى وإن كانت نيتها خبيثة وراء ذلك. فهي، على كل حال، اختارت السبيل الأمثل للتقرب من الأمازيغي في حين نجد الطرف الآخر، في الحقيقة، لم يضف شيئا إلى هذا الشمال الإفريقي اللهم إلا سعيه الحثيث لشرقنته وتعريبه وتخريبه، أما بعض المهرجين الذين لم يعتادوا طبعا على غير النظام الأوتوقراطي وأحادية الرأي السديد، ولم يتربوا على غير الاستبداد والاستفراد والاستقراد، فهم يفسرون ذلك بأنه تمهيد لاستعمار آخر، وأن أولائك الأمازيغ الباحثين عن تاريخهم وعن ثقافتهم، التي أضاعها بعض الضيوف المعززين المكرمين، هم مجرد منبطحين يعملون على استقدام الاستعمار ليس إلا. ومما يثير الضحك، لدى بعض المفكرين المحسوبين على العرب، كالعادة هو أنهم ينسون أو يتناسون، بالمرة، أن الأمازيغ هم الذين خلصوا البلاد والعباد من الاستعمارات والاستخرابات في هذا الشمال الإفريقي طوال التاريخ. وفي ظل هذا المنطق أصبحنا لا ندري حقا ما الذي أصاب الباحثين عن أطلال «طروادة» أو جزيرة «أطلنتيس» المفقودة، فمن المؤكد أن هذا النوع من الأعراب (وليس العرب الشرفاء) لا يتوانى عن القول بأن غريزة الاستعمار هي التي تقف وراء ذلك لا أكثر ولا أقل. ولهذا لا ندري ما هو الشيء المنزه عن الاستعمار يا ترى، وكأنهم لا يدركون بأن ما يرسخونه، هم أنفسهم، لم يفتأ يتخذ منحاه الاستعماري بأسوأ أشكاله! وإلا فنحن نتساءل بجدية: أفلم يكن من الحكمة ألا يجحد السكان الأصليون لهذا الشمال الإفريقي ويعملوا ما بوسعهم من أجل النهوض بالثقافة الأمازيغية الأصيلة التي يفترض أن تكون ثقافتهم، ما داموا قد اختاروا القدوم إليها من أقصى الدنيا، كما فعل الأمازيغ القدماء الذين حكموا مصر واندمجوا في ثقافتها وبإخلاص كما رأينا سالفا؟ ترى ما الذي أبقوه للحديث عن الاستعمار وهم لا يسمون الأمازيغ إلا «برابرة»؟؟ حتى أننا أصبحنا نتعرف على نسب وحسب الكاتب من خلال هذه التسمية وحدها. فعندما ترى كلمة «بربر» أمامك، سواء في كتاب أصفر أو أزرق، فاعلم أن الأعرابي هو الذي كتبها. وبعد هذا وذاك يأتي أكثرهم تهريجا ليعلِّم الأمازيغ الفرق بين الاستعمار والاستقلال، أي أن الباحثين الأمازيغ وغيرهم في المعاهد والأكاديميات الأجنبية المخصصة للثقافة الأمازيغية، المطرودة من عقر دارها، هو استعمار محض، أما انتهاج الشتم والسب اليومي في عقر الدار الأمازيغية فهو استقلال محض. إحالات: [1] مصطفى كمال عبد العليم، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، ص 57، المطبعة الأهلية بنغازي 1966. [2] سيد كريم، لغز الحضارة الفرعونية، ص 29 ، 30، طبعة 1996. [3] المرجع السابق، ص 24 [4] أحمد عبد الحليم دراز، مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م، ص 20، نسخة إليكترونية عن موقع تاوالت الثقافي، www.tawalt.com[5] المرجع السابق، ص 56 [6] مصطفى كمال عبد العليم، المرجع السابق، ص 23 [7] المرجع السابق، ص 32 [8] المرجع السابق، ص 33 [9] هرودوت يتحدث عن مصر، ص 108، ترجمة محمد صقر خفاجة، 1966 [10] سيد كريم، المرجع السابق، ص 29[11] أحمد عبد الحليم دراز ، المرجع السابق، ص 58 [12] مصطفى كمال عبد العليم، المرجع السابق ، ص 32، 33 [13] المرجع السابق، ص47 [14] المرجع السابق، ص 33 [15] المرجع السابق، ص 33 [16] المرجع السابق، ص21، ثم انظر: إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج 1، ص 78،79، الطبعة الثانية، القاهرة 1960 [17] المرجع السابق، ص 21 ، وانظر: E.S.G Robinson, Catalogue of the Greek Coins of Cyrenaica (M.B.C.), London, 1927, PP.Ixxxviii-Ixxxvii, A.H.M. JonesOp.cit.P.358 [18] هيرودوت يتحدث عن مصر، ص 182 [19] المرجع السابق، ص 366[20] أحمد عبد الحليم دراز، المرجع السابق، ص 61 ، ثم راجع: فوزي جاد الله ، مسائل في مصادر التاريخ الليبي قبل هيرودوت، ليبيا في التاريخ، ص 68: بنغازي، 1968 [21] مصطفى كمال عبد العليم، المرجع السابق، ص 31 ، ثم راجع: سليم حسن، مصر القديمة، ج 7 القاهرة. ص 323 وما يليها[22] هيرودوت يتحدث عن مصر، 94 [23] المرجع السابق، ص 94 ، الهامش رقم 1 [24] تاريخ هيرودوت، الكتاب الثاني، ص 140، ترجمة عبد الإله الملاح [25] المرجع السابق، ص 703 الهامش رقم 9 [26] المرجع السابق، ص150 [27] المرجع السابق، 151 [28] أحمد عبد الحليم دراز، المرجع السابق، ص 20 [29] المرجع السابق، ص 21 [30] المرجع السابق، ص 21 [31] مصطفى كمال عبد العليم، المرجع السابق، ص 70 [32] جاءت في هذه الطبعة "أعضاد" ، انظر المرجع السابق، ص39 [33] المرجع السابق، ص39 [34] هيرودوت يتحدث عن مصر، ص 264 [35] المرجع السابق، ص264، الهامش رقم 2. [36] المرجع السابق، ص 264 . [37] هرودوت يتحدث عن مصر، ص 264-265 [38] المرجع السابق، ص 265 [39] المرجع السابق، ص 265 [40] المرجع السابق، ص 265 [41] المرجع السابق، ص 265-266 [42] المرجع السابق، ص 265 [43] مصطفى كمال عبد العليم، المرجع السابق، ص 60-61 [44] المرجع السابق، ص 61 [45] المرجع السابق، ص 61 [46] المرجع السابق، ص 61 ثم راجع: C.H. Kracling, op. cit. P.17[47] مصطفى كمال عبد العليم، المرجع السابق، ص 57 ، ثم انظر: S.Applebaum, The Jewish Revolution. P.180 [48] المرجع السابق، ص 57، ثم انظر: اتيين ديورتون، وجاك فاندييه، مصر، ص637، القاهرة تعريب عباس بيومي [49] المرجع السابق، ص 57، ثم انظر: S.Applebaum, The Jewish Revolution. P.180 [50] وول ديورانت، قصة الحضارة، ج1، ص 552 ترجمة د. محيي الدين صابر.[51] سفر الملوك الأول، الإصحاح الرابع عشر، الآية: 25-26-27 **** (سعيد بودبوز/كاتب مغربي Said_bz@hotmail.com)
|
|